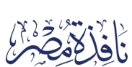أشار الكاتب جيسون بورك إلى أن مشهد التدخل الأمريكي الحالي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة يذكّر بتجربة مشابهة قبل أكثر من أربعة عقود، حين تدخّل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان لوقف الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982. حينها، دمّر القصف الإسرائيلي أحياء كاملة من العاصمة اللبنانية، وسقط آلاف القتلى، بينما اكتفى المجتمع الدولي بالمشاهدة. لم يكن الهدف حينها “حماس”، بل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. ومع اختلاف السياقات، تتكرّر الصورة ذاتها: رئيس أمريكي يتأثر بصور الأطفال الجرحى على الشاشات، فيضغط على إسرائيل لوقف القتال مؤقتاً دون معالجة جذور الصراع.
ذكرت الجارديان أن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة جاءت بدافع مشابه لما فعله ريجان قبل عقود، بعد أن شاهد صور المجاعة والدمار. لكن الفارق الزمني لم يُغيّر شيئاً في السردية الإسرائيلية، إذ لا تزال الحكومة تزعم أن معظم الضحايا مقاتلون، وأن الفصائل الفلسطينية تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، تماماً كما فعلت تل أبيب لتبرير اجتياح بيروت. في الحالتين، جرى تصوير الحرب كـ"دفاع مشروع"، فيما تحوّلت المدن إلى أنقاض.
يستعيد بورك مشهد عام 1982 حين ضغط ريجان على رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، محذراً إياه من أن ما يجري في بيروت “هولوكوست”، ومطالباً بوقف القصف. بعد وقف النار، تشرّدت منظمة التحرير بين عواصم عدة، واغتيل الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميّل، فارتكبت الميليشيات المسيحية مجازر مروّعة بحق الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا، وسط تقاعس القيادات الإسرائيلية. عادت القوات الأمريكية إلى لبنان في محاولة فاشلة لحفظ السلام، لتجد نفسها بعد شهور هدفاً لتفجيرات انتحارية أسفرت عن مئات القتلى، وأعلنت انسحابها سريعاً. من تلك الفوضى وُلد حزب الله، الذي أصبح لعقود العدو الأخطر لإسرائيل في الشمال.
يرى بورك أن ما جرى في لبنان يقدّم درساً واضحاً لغزة: أي فراغ سياسي بعد الحرب سيفتح الباب أمام قوى جديدة أكثر تشدداً. فكما أدّت الفوضى في الثمانينيات إلى صعود الإسلاميين على أنقاض الحركات القومية واليسارية التي تراجعت أو اندثرت، فإن انهيار البنية السياسية في غزة قد يعيد إنتاج المشهد ذاته. بعد أن كانت التنظيمات الفلسطينية ذات طابع وطني وعلماني، حلت محلها حركات مسلحة ذات طابع ديني، تجيد العمل السري.
يشير الكاتب إلى أن الغرب لم يتعلّم من تلك التجربة. ففي السبعينيات، حاولت أجهزة المخابرات والباحثون فهم أسباب العنف السياسي وتحليل دوافع “التطرّف”. لكن مع مطلع الثمانينيات، تراجع هذا المنهج، وأصبحت التفسيرات بسيطة وسطحية: الإرهابيون “مجانين” أو “عملاء لموسكو”. تجاهل الغرب العوامل الاجتماعية والسياسية التي تُغذّي العنف، فتحوّلت المنطقة إلى أرض خصبة لجماعات أكثر قسوة وتنظيماً.
يُبرز بورك تشابهاً آخر بين ريجان وترامب: كلاهما أدرك في لحظة متأخرة أن القوة العسكرية وحدها لا تصنع السلام. في عام 1982، قال ريجان لإسرائيل إن جيشها لن يجلب “سلاماً عادلاً ودائماً”، واعترف بـ“الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”. بعد أكثر من أربعين عاماً، أبلغ ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تستطيع محاربة العالم بأسره، مضيفاً بنداً في خطته يلمّح إلى “تطلعات الفلسطينيين نحو دولة”، وإن حُذف منها وصف “الحقوق المشروعة” إرضاءً لتل أبيب.
تكرّر التاريخ بطريقة ساخرة. فخطة ريجان سقطت في النسيان بعد أشهر، وأُصيبت واشنطن بالملل من الملف الفلسطيني، لتندلع الانتفاضة الأولى عام 1987، وتولد حركة حماس من رحم الإحباط والغضب. واليوم، يحذّر بورك من أن خيبة الأمل من خطة ترامب قد تُطلق دورة جديدة من المقاومة، وربما موجة عنفٍ أشدّ تنظيماً وامتداداً.
يختم الكاتب بأن كل “هدنة سلام” في الشرق الأوسط وُلدت وسط بحر من الدماء. الولايات المتحدة تدعو دوماً إلى إنهاء العنف، لكنها تترك وراءها فراغاً تملؤه قوى أكثر تطرفاً. إسرائيل تكرر سياساتها نفسها، والفلسطينيون يُدفعون مجدداً إلى اليأس. وهكذا، كما في بيروت 1982، يبدو أن غزة 2025 ليست نهاية حرب، بل بداية فصل جديد منها — فصلٌ يذكّرنا بأن السلام في هذه الأرض ليس اتفاقاً يُوقَّع، بل درسا لم يُفهم بعد.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/oct/15/israel-palestine-peace-ronald-reagan-war